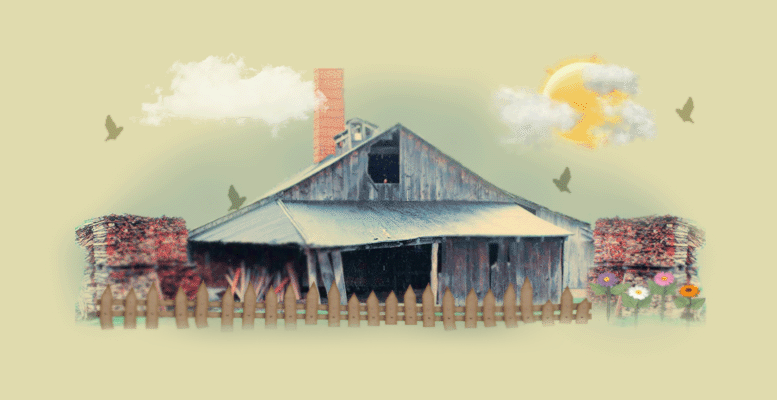قد تنشب مجادلات حامية الوطيس، وتتفرع المسائل وتطول المحاكمات، ولكنك بعد البحث والتنقيب تكتشف أن البنية التحتية للقضية مبنية على باطل، وما بُني على باطل فهو باطل.
وهذا كتعليل المسائل بما يسميه الأصوليون الوصف الطردي أو العلة غير المؤثرة.
فحين يتشبث إبليس بمثل هذا الوصف الطردي رافضاً السجود؛ لأنه مخلوق من نار، وآدم عليه السلام من طين يقطع عليه ربنا –سبحانه- حجته بأن هذا وصف طردي غير مؤثر، ويبيّن له أن العلة هي وجود الأمر الإلهي: (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ).
ومثل هذه المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، والفضل لم يربطه الشارع بهذا، وإنما ربطه بالتقوى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).
وكذلك أيهما أعظم درجة وأزكى عند الله: المسائل العلمية أو العملية؟
والشارع لم يجعل هذا مناطاً للتعظيم، وإنما جعل ذلك بالقطعي منهما.
ونحوه المقارنة بين الانحراف العقدي، أو الانحراف الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو الفقهي، أو نحو ذلك؛ فالشريعة لم تربط الانحراف بهذه الأشياء، وإنما قرنته بمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة أو ارتكاب الكبائر أياً كان نوعها.
ومن ذلك قبول خبر الآحاد في العقائد؛ فإن هذه المسألة لا يصح فيها القول بالنفي أو الإثبات؛ لأنها مبنية على باطل، وهو التقسيم المعتزلي للشريعة إلى مسائل عقدية ومسائل فقهية، والحق تقسيم الشريعة إلى قطعية وظنية، سواء في العقيدة أو في الفقه.
وبعد هذا ننتقل إلى قبول خبر الآحاد في المسائل القطعية، فنقول بأن المسائل القطعية لا يمكن أن تُبنى على خبر آحاد عقلاً –والشرع لا يخالف العقل-، لأن المسألة لم تكن قطعية إلاّ بما توفر فيها من أدلة بلغت حد التواتر، ولا توجد مسألة قطعية دينية أو دنيوية بُنيت على خبر آحاد، وسواء في ذلك مسائل العقيدة أو مسائل الفقه.
وأما المسائل الظنية فقبول خبر الآحاد فيها سواء في العقيدة أو في الفقه هو الحق، ولو لم يعمل بهذا لتعطلت الشريعة.
ومن ذلك مقابلة العقل بالشرع، والعقل جزء من الشرع، وليس نظيراً له، والصحيح أن يقابل العقل بالنقل، والأدلة الشرعية قائمة على النقل والعقل، وكلاهما في الشريعة كفرسي رهان، أيهما سبق فهو أحق، فإذا كان العقل قطعياً والنقل ظنياً وجب تقديم العقل، وإذا كان النقل قطعياً والعقل ظنياً وجب تقديم النقل، وإذا كانا ظنيين فمحلّ اجتهاد.
ومن ذلك بناء الأحكام على مصطلح (البدعة) كتوبة المبتدع وشهادته والرواية عنه ومعاملته وغير ذلك، والبدعة كمصطلح له دلالته لم يظهر تقريباً إلاّ بعد الصراع الأشعري المعتزلي، والتوبة إما من كفر أو ذنب، والشهادة إما من مسلم فاسق أو غير فاسق أو كافر، والرواية إما من حافظ صادق أو غير حافظ أو صادق، والمعاملة بحسب المصلحة حتى مع الكافر.
وأيضا فالأحكام المترتبة على مصطلح (البدعة) كلها أحكام مبنية على مصطلح لم يبنِ الشارع الأحكام عليه، بل ليس هناك حديث صحيح ورد فيه لفظ البدعة إلاّ حديث واحد، وهو حديث "كل بدعة ضلالة".
ومن ذلك لفظ الجسم والحيز والحد، ونحو ذلك من الاصطلاحات الفلسفية التي يَفترض فيها المتكلمون أنها صفات نقص، وبناء عليه يمنعون اتصاف الباري -جل وعلا- بها.
وهنا قبل أن نمنع أو نثبت اتصاف الباري -عز وجل- بها يجب أن نفكك هذه المصطلحات؛ لنثبت ما كان حقاً، ونبطل ما كان باطلاً.
ومن ذلك لفظ (الزنديق) وترتيب الأحكام على الزندقة، وهذا المصطلح الفارسي لم يظهر بين المسلمين إلاّ في دولة بني العباس حين كان الوزراء من الفرس، وهو مصطلح سياسي أكثر من كونه مصطلحاً دينياً، وليس في الشريعة (زنديق) وإنما في الشريعة: مسلم وكافر ومنافق.
ومن ذلك ما ينتشر في هذا العصر من مصطلحات فلسفية أو غربية كالعلمانية أو نحوها- لا ينبغي أن نتحدث فيها عن أحكام شرعية إلاّ بعد تشريع تلك المصطلحات وإخضاعها للنصوص الشرعية